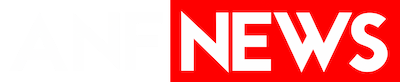كانت نشأة الصحافة الكُردية في مصر، فقد صدرت أول صحيفة كردية في التاريخ من القاهرة وهي صحيفة كردستان التي صدرت في إبريل/ نيسان 1898م على يد مقداد بك بدرخان. وليس هذا فحسب ففي عصر الراحل الزعيم عبد الناصر قامت علاقة وطيدة بينه وبين الكُرد، وكان يرى أن لهم حقوق لغوية وثقافية وسياسية يجب أن يتمتعوا بها في البلاد العربية، وأتاح لهم أن يطلوا على العالم من خلال محطة إذاعية كردية من القاهرة كانت الأولى من نوعها في عام 1957م. كما استقبل بعض من قادة الكرد وأنشأ علاقة متواصلة معه. ويعتبر الكثير من الدارسين لمفهوم الأمن القومي العربي أن الشعب الكردي يشكل أحد مقومات الأمن القومي العربي، منذ التاريخ وحتى اليوم وخاصة في السنوات الأخيرة لما لعبه الكرد في دور مهم في هزيمة داعش والتنظيمات التكفيرية.
وفي هذا الصدد كتبت دكتورة سحر حسن أحمد مقال عن أحد أهم الأُسر الكُردية العريقة التي لعبت دوراً بارزاً في التاريخ الثقافي المصري الحديث. ألا وهي الأسرة التيمورية، بيد أن تلك الأسرة قد أثرت الكثير والكثير، فالحديث عنها ثرى وممتع. بدايةً تطرقت إلى طرح بعض التساؤلات منها، كيف أتت تلك الأسرة إلى مصر ومتى؟ ومن هم نسلها؟ وما هو الدور الذي أسهموا به في إثراء الثقافة المصرية؟ إذ ألقت في البداية الضوء على رأس هذه الأسرة محمد بن إسماعيل الذي جاء إلى مصر من جنوب كردستان (شمالي العراق).
عميد الأسرة التيمورية بمصر (1765 -1848م)

محمد تيمور بن إسماعيل بن علي من أسرة كردية كانت تسكن « بقره جولان » التابعة لجنوب كردستان من ولاية الموصل - العراق، وقد أصاب مدينة قره جولان الخراب بعد بناء مدينة السليمانية الحديثة عام 1784م. وقد تركها إثر حدوث قطيعة وقعت بينه وبين أخيه، وعندما تركها جاء إلى مصر وكان حاملاً ثقافته الكُردية التي كانت سائدة في بلاده حينذاك، وكان يعرف اللغة الكُردية اللغة الأم والفارسية الدواوين وكذلك التركية الرسمية في الدولة العثمانية ثم اللغة العربية. وقام بالالتحاق بالجيش العثماني، وجاء إلى مصر ضمن الجنود التي أرسلها السلطان العثماني سليم الثالث ابن السلطان مصطفى الثالث ( 1789- 1807م ) إليها بعد خروج الفرنسيين منها عام 1801م، وفي ذلك الوقت نشأ بين محمد الكاشف وبين محمد علي باشا تآلف وصداقة بشكل كبير، ظهر أثرها بعد تولى محمد علي سُدة الحكم في مصر؛ فإنه لم يكد يرتقى الحكم، حتى أخذ بيد محمد تيمور معه وتدرَّج به في الارتقاء حتى جعله من كبار قواده، وكان يستشيره في كثير من أمور الدولة، وكان لا يُخاطبه إلا بالفظ " أركداش " أي الأخ أو الرفيق في اللغة التركية. وقد انتقلت هذه المحبة من محمد علي إلى ابنه إبراهيم فاتصلت بينه وبين إبراهيم باشا.
وقد اعتمد عليه الباشا في كثير من شؤونه، "كمذبحة القلعة 1811م"، وغيرها مما كان يُقدم عليه أو يُقوم به في وجهه من المؤامرات والفتن، ولم يُقصره على الجندية بل ولَّاه عدة أعمال من قبيل "الكشوفية"، ومنها لزمه لقبُ الكاشف الذي كان يُلقَّب به حتى بعد ترْكه تلك الأعمال. وقد عيّنه الوالي على إمارة المدينة المنورة 1837م لمدة خمس سنوات، ثم عزل منها ولم يعد للمناصب ثانية لتقدم سنه، وبعد ذلك انقطع للعبادة إلى أن تُوفي عام 1848م عن سن ناهز الثمانين من عمره، ودُفن في مرْقَده الذي أعده لأسرته بالقرب من مقام الإمام الشافعي. أما لقبه (تيمور) فكلمة تركية الأصل، مصاغة من كلمة ( دَمِرْ) التركية، وتعني بالعربية (حديد)، وكان هذا اللقب يُطلق عادة على الرجال الأقوياء والشجعان، وذوي الإرادة الفولاذية.
إسماعيل تيمور باشا (1815-1872م)
ولد إسماعيل تيمور في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1815م ، ولقبهُ والده بإسماعيل رشدي ولكن لقب العائلة طغى على لقبه، وكان منذ صغره يميل إلى الاشتغال بالعلوم والآداب؛ فتعلم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، كما تعلم التركية والفارسية والكُردية، وأتقن أنواع الخط، وبرع في الإنشاء التركي العثماني براعة لم يُضاهيه فيها أحد من أقرانه، كان شغوفًا بالعلم والعلماء لا يخلو مجلسه منهم، كما كان شغوفاً بالمُطالعة، كان يرى أن أسعد أوقاته هي التي يقضيها في قراءة كتاب أو تحقيق مسألة، كان مُولعاً باقتناء الكتب النفيسة، وشرائها واستنساخها، والإقبال عليها، وكان لديه مكتبه نادره، بيد أن المجهود الشاق الذي بذله في جمع الكثير من أمهات الكتب ضاع هباءً منثوراً؛ إذ تشتَّت وتفرَّقت المكتبة بعد موته ولم يبقَ منها إلا فهرس الأسماء فقط، حتى كتابه الذي عُنى بتأليفه وأودعه خلاصةَ مُطالعاته مُحاكيا به سفينة راغب باشا، ذهب مع ما ذهب من أوراقه.
وقد أُعجب به محمد علي واتخذه كاتباً خاصاً له، وكان يعرض عليه كل الأوراق الرسمية التي تحتاج لمراجعة، كما كان يقوم بتبليغ أوامره إلى رؤساء الديوان، ثم جعله وكيلاً لمديرية الشرقية ومديراً لبعض المديريات كان آخرها الغربية، ولكنه كان مع هذا شديد التعلق بالقاهرة والعودة إلى مناصب الديوان، حتى عاد إليها بناءً على رغبته الشخصية.
بعد تولى إبراهيم باشا الحكم في عام 1848م، أمر بتأليف "الجمعية الحقانية الثانية "، وعين إسماعيل تيمور رئيساً لها. وتم نشر هذا في جريدة الوقائع المصرية بعدد يوم الاثنين 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1848 م. وبعد ذلك رُقي في عهد عباس باشا (1849 – 1854م) إلى وكالة "ديوان كتخدا" وهو أكبر ديوان آنذاك، ورئيسه يُعد من أكبر رجال الحكومة بعد الوالي؛ فهو يُشبه رئيس الوزراء الآن. ثم عُزل منه بناءً على وشاية من بعض حاقديه، إلى أن تبين للوالي كذب الواشي، فدعاه وأظهر له الرضاء وأقامه ناظراً على خاصَّته المُسمَّاة ﺑ "الدائرة الآصفية " فقَبِلَها، وإن تكن دون منصبه الأول، وبقي فيها إلى وفاة عباس باشا 1854م.
وفيما تولى سعيد باشا حكم مصر في عام 1854م، ولاه رئاسة ديوانه، ثم حدث ما أغضب الوالي فقام بتوبيخ رجال ديوانه، كبيرهم وصغيرهم، وعلى إثر هذا أرسل إسماعيل تيمور طلب إعفاءه من منصبه فلم يُعفه، ولم يوافق في بداية الأمر ولكنه أصر حتى أعفاه.
وفي عصر الخديوي إسماعيل باشا (1863 -1879م)، ظل إسماعيل تيمور لوقت طويل من فترة حكمه بعيداً عن مشاغل الحكومة، متنقلاً بين كُتُبه وضِياعه، وكان دائماً يعتذر عن المناصب، وبعد الإنعام عليه برتبة الباشاوية، عُين ناظراً لخاصة ولي العهد محمد توفيق باشا فقبلها رغماً عنه، بيد أنه ظل في هذا المنصب لمدة لا تتعدى ستة أشهر حتى وافته المنية 25 ديسمبر/ كانون الأول 1872، ودُفن بجوار والده. وعندما تُوفى كان له من الأبناء ثلاثة بنتان وولد، وكانت عائشة التيمورية أكبرهم.
عائشة عصمت التيمورية (رائدة الأدب النسوي في مصر) (1840-1902م)
عُدت عائشة درة تاج الأسرة التيمورية، وقد وُلدت عائشة التيمورية عام 1840م، بمدينة القاهرة من أم جركسية الأصل، وبدأت والدتها في تعليمها الفنون النسوية مثل الحياكة والتطريز، لكنها كانت ميالة إلى التعلَّم ولما استشعر فيها والدها ميلها هذا أحضر لها بعض المدرسين الذين حفظت على أيديهم القرآن الكريم كاملاً، كما تعلمت الفقه والنحو والصرف واللغة الفارسية، وكان لديها شغف إلى مُطالعة الكتب الأدبية، وفي مقدمتها الدواوين الشعرية، حتى تربَّت لديها ملكة التصورات لمعاني التشبيهات الغزلية وسواها. ثم بدأت تكتب بعض ما تجود به قريحتها.
تزوجت عائشة في سن مبكرة في الرابعة عشر من عمرها من محمد توفيق بك نجل محمود بك الإسلامبولي ابن السيد عبد الله أفندي الإسلامبولي، كاتب ديوان همايوني بالآستانة سابقاً، وكان ذلك في عام 1854م، فتفرغت للشؤون الزوجية وتدبير البيت، ولا سيما بعدما رزقها الله بالأطفال. وبعد وفاة زوجها هيأت لها الحياة الرغدة بعد زواجها أن تستزيد من الأدب واللغة، فاستدعت سيدتين لهما إلمام بعلوم الصرف والنحو والعروض، ودرست عليهما حتى برعت، فأتقنت نظم الشعر باللغة العربية، كما أتقنت اللغتين التركية والفارسية والتي أخذتهما عن والديها، وكانت تُنشد القصائد المطولة والأزجال المنوعة والموشحات البديعة التي لم يسبقها أحد على معانيها.
وكتبت ثلاث دواوين شعرية نظمتها بالعربية والفارسية والتركية، وسجل التاريخ لعائشة أن نثرها وشعرها أول ما عرفته مصر من الأدب النِّسْوي في العصر الحديث. وحين شرعت في طبْع هذه الدواوين تُوفِّيت ابنتها الكبرى توحيدة وهي في الثامنة عشرة من عمرها فاستولى عليها الحزن، وتركت الشعر والعروض والعلوم نحو سبع سنين، ثم عادت فجمعت ما عثرت عليه من أشعارها في ديوانٍ باللغة التركية سمَّته "كشوفة" طبعته في الآستانة، وفي ديوان آخر لها باللغة العربية أسمته "حلية الطراز".
وكان لها عدد من المقالات في جريدة الآداب والمؤيد عارضت فيها آراء المفكر قاسم أمين (1863 -1908م)، وكانت أسبق في الدعوة إلى تحسين أحوال المرأة والنهوض بها من قاسم أمين، ومهدت السبيل في مجال المقالة الاجتماعية لباحثة البادية ملك حفني ناصف (1886 – 1918م).
ولها رسالة قصيرة بعنوان (مرآة التأمل في الأمور) ناقشت فيه حقوق الرجال على النساء من خلال آية القوامة وقدمت تفسيراً لا يخرج عن التأويل الإسلامي لكنه يصطدم بالأفكار والممارسات الاجتماعية في عصرها وكانت عبارة عن 16 صفحة طبعتها قبل عام 1893م..ثم رأت نفسها قادرة على التأليف، فألَّفت كتابًا سمَّته "نتائج الأحوال في الأقوال والأفعال" وطبعته عام 1888م، ثم تابعت نشر مؤلفاتها نثراً وشعراً بعد ذلك، وقد لقيت جميعُها الإقبال والانتشار. وانتهت حياتها بعد صراع طويل مع المرض فقد تُوفيت في 24 مايو/ أيار 1902م.
أحمد تيمور فارس العربية (1871 – 1930م)
وُلد في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1871م، وسمَّاه والده يوم ولادته بأحمد توفيق؛ وكان يُنادى في صغره بتوفيق، هو أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور الكاشف بن علي، الذي وُلد بالقاهرة في درب سعادة، نشأ أحمد يتيماً فلم يكد يمض على ولادته سنتين حتى مات أباه وقد ذكر الزركلي في قاموس تراجم الأعلام أن والده تُوفي وهو ذات الثلاثة أشهر -وبالرغم من إنه لم يُعاصره لكنه ورث من أبية حب العلم والمُطالعة واقتناء الكتب والمخطوطات -ومن ثم قامت أخته الكبرى عائشة بتربيته. وتعلم أحمد تيمور اللغات الشرقية وكذلك تعلم اللغة الكُردية الفارسية والفرنسية ومبادئ العلوم في مدرسة مارسيل الفرنسية، ودرس العلوم العربية والإسلامية على يد الشيخ حسن الطويل، والإمام محمد عبده والشيخ الشنقيطي وحسن عبد الوهاب.
وانقطع تيمور عن الدراسة النظامية بعد بضع سنوات وتلقى تعليمه في المنزل؛ حيث تعلم الفارسية والتركية، واكتفى بمتابعة ضِياعه ومسامرة كتبه وإعادة النظر فيما بدأ فيه من العلوم العربية والفنون الأدبية؛ وبعد وفاة الشيخ حسن الطويل صحب إمامَ اللغة الشيخ محمد محمود الشنقيطي الشهير، فقرأ عليه المعلقات السبع روايةً ودرايةً وكثيراً من دواوين العرب التي كان يرويها وبعض الرسائل اللغوية، واستفاد منه فوائدَ جمَّةً صرفتْه إلى الاشتغال باللغة بعد أن كان مقتصراً على الأدب والتاريخ، وكان متمسكاً باللغة العربية والهوية الإسلامية أكثر من كثير من الأدباء العرب، ورفض الانضمام إلى جمعية طورانية تضم غير المصريين.
وقد كوَّنَ وهو ما زال لم يكمل سن العشرين مَكتبة شَخصية بلغ قوامها ثمانية آلاف مجلد، نِصْفُها من المَخْطُوطات، ثم توسَّع فيها مع السن والزمن حتى أصبحت أكبر خزانة كتب بمصر من حيث العدد بعد داري الكتب الخديوية المصرية والأزهرية، وأما من حيث النفاسة والغرابة فقد وُجِد فيها ما ليس فيهما. وتزايد عدد مقتنياتها مع الوقت حتى بلغت 18 ألف مجلداً حسب ما ذكر الزركلي. ووُصِف أحمد تيمور باشا بأنه صاحب شخصية موسوعية أميل إلى النمط الأكاديمي، وأن شخصيته ناقدة قادرة على البحث والتحليل.
وقد أنعم عليه الخديوي عباس حلمي الثاني ( 1892 -1914م) بالرتبة الثانية عليه في عام 1897م، وعندما أنشئت الحكومة مجلساً عالياً للنظر في شؤون دار الكتب الخديوية المصرية والإشراف على إحياء الآداب العربية، في أول يوليو/تموز سنة 1911 م تم انتخابه عضواً فيه، ولكنه استقال منه في نوفمبر/تشرين الثاني 1912م لكثرة أشغاله وجنوحه إلى العزلة، وكأنه ورث هذه السجية من والده كما ورثَ أبناؤه حب العلم والمعرفة؛ وكان يقضي غالبَ أوقاته منفرداً بكتبه في ضيعته بقويسنا (مديرية المنوفية) لا يُخالط كبيراً ولا صغيراً، ولا يُفضِّل عليها سميراً.
وقد أُنعم عليه السلطان فؤاد الأول (1918-1936م) برتبة الباشوية عام 1919م، وفي 23 فبراير/شباط 1924 م صدر مرسوم ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشيوخ، ولم يَدُم طويلًا في هذا المنصب؛ إذ استقال من المجلس بعد ذلك. وفي ذات الوقت قرَّر السلطان فؤاد تعيينه عضواً بمجلس إدارة دار الكتب الأعلى للمرة الثانية. كذلك اُختير عضواً في لجنة إصلاح الأزهر عامذاك، وقدم جهدا بارزاً في لجنة إحياء الكتب العربية التي أسسها الإمام محمد عبده عام 1924م
تزوج أحمد تيمور باشا عام 1889 م من خديجة هانم بنت أحمد رشيد باشا ناظر الداخلية، الذي كان صديقاً حميماً لوالده، ورُزق منها أولاده الثلاثة إسماعيل ومحمدومحمود ، ثم تُوفيت عام 1899م؛ فلم يتزوج تيمور بعدها. تُوفى ابنه محمد في عام 1921م، وقيل أنه جزع لذلك ثم لازمته نوبات قلبية انتهت بوفاته عام 1930م.
لأحمد تيمور ما يزيد على سبعة وعشرين مؤلفاً، أغلبها مطبوع، إلى جانب قسم منها مخطوطاً، نذكر منها،أعلام المهندسين في الإسلام (كتاب) ، أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث، الآثار النبوية، الأمثال العامية، مشروحة ومرتبة حسب الحرف الأول من المثل وتاريخ العلم العثماني، ضبط الأعلام، لعب العرب، الحب والجمال عند العرب، لهجات العرب ، التصوير عند العرب، نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة، تصحيح لسان العرب، تصحيح القاموس المحيط، اليزيدية ومنشأ نحلتهم (رسالة)، البرقيات للرسالة والمقالة، قبر السيوطي- ط رسالة ، أبو العلاء المعري وعقيدته ، الألقاب والرتب، معجم الفوائد، هو الأم لمؤلفاته كلها، أعيان القرن الرابع عشر، الكنايات العامية، تراجم المهندسين العرب- ط نشره في مجلة الهندسة، نقد القسم التاريخي من دائرة فريد وجدي، التذكرة التيمورية - ط مجلدان، السماع والقياس، أبيات المعاني والعادات، المنتخبات في الشعر العربي، تاريخ الأسرة التيمورية، أسرار العربية، أوهام شعراء العرب في المعاني، ذيل طبقات الأطباء، مفتاح الخزانة، فهرس لخزانة الأدب للبغدادي، ذيل تاريخ الجبرتي، الألفاظ العامية المصرية، قاموس الكلمات العامية، ستة أجزاء، ووضع تيمور باشا فهرساً ورقياً بخطه لمكتبته، وجعل لكل فن فهرساً مستقلاً خاصاً، وكانت هذه الفهارس موجودة في قاعة المخطوطات بمبنى دار الكتب القديم بباب الخلق متاحة للباحثين.
إذ تألفت بعد وفاته لجنة لنشر مؤلفاته تعرف بـ " لجنة نشر المؤلفات التيمورية " التي أخرجت العديد من مؤلفاته. جمع أحمد تيمور باشا مكتبة قيمة غنية بالمخطوطات النادرة ونوادر المطبوعات (نحو 19527 مجلداً وعدد مخطوطاتها 8673 مخطوطاً)، أُهديت إلى دار الكتب بعد وفاته. وقد دون تيمور باشا بخطه على أغلب مخطوطات مكتبته ما يُفيد اطلاعه عليها وسجل على أول المخطوط بخطه "قرأناه" وكان يُعد لكل مخطوط قرأه فهرساً بموضوعاته ومصادره وأحياناً لأعلامه ومواضعه ويضع ترجمة لمؤلف الكتاب بخطه. وهكذا كان الأديب والمفكر الذي قدم للأدب مكتبة كبيرة ومتنوعة من مؤلفاته التي أثرت الحياة الثقافية في مصر.
محمد بك تيمور (1892 -1921م)
هو محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور الكاشف، وُلد في القاهرة عام 1892م، وتُوفى بها في 1921م، وقد أتم تعليمه بالمدارس الأميرية، ثم سافر إلى أوروبا لإتمام علومه، فقضى فيها ثلاثة أعوام. ولما قامت الحرب العالمية الأولى سنة 1914م، كان محمد تيمور في مصر يقضى إجازة الصيف؛ فلم يستطع العودة لإتمام دروسه نتيجة ذلك، فالتحق بمدرسة الزراعة العليا ثم تركها؛ لأنها لم توافق ميوله الأدبية، وكذا لم يستطع أن يتم دروسه بالحقوق الفرنسية، فاتجه اتجاهاً أدبياً يتوافق مع اتجاهاته وميوله؛ إذ اتجه إلى المسرح والتمثيل والتأليف لهما.
انقسمت حياته إلى ثلاث مراحل: الأولى وهي مرحلة التعليم الإلزامي بمصر والتي نمت فيها وبرعت مواهبه. والثانية: مرحلة التعليم الجامعي بأوروبا والثالثة والأخيرة: مرحلة عودته لمصر، بيد أن مواهبه تكونت منذ أن كان في المرحلة الابتدائية. فقد كان شغفه كبيراً بالأدب والمسرح منذ الصغر، فاستطاع أن يَنظِم الشعر وهو في سن العاشرة، وقد ظهرت له مقالات في الصحف وهو لم يُغادر تلك المرحلة، وكان محباً للصحافة فقضى أوقاتاً كثيرة في تحرير الجرائد المنزلية. ولشغفه بالشعر قرأ دواوين لكثير من الشعراء كالمتنبي والمعري وأبي نواس فارتقى شعره، وكان يكتب قصائد في مناسبات المدرسة، فأطلقوا عليه شاعر المدرسة الخديوية.
أما علاقته بالتمثيل فكانت قوية منذ الصِّغَر؛ فقد ملك عليه هذا الفن جوارحه واستهوى قلبه، وساعد ميلَه هذا نمواً وازدهاراً ترُدده على فرقة الشيخ سلامة حجازي لمشاهدة رواياته، وبلغ من شدة تعلقه بهذا الفن أن ألَّف فرقة تمثيلية عائلية كان هو بطلها ومؤلفها التمثيلي؛ فكان يُعد أول رائد لفن التمثيل والتأليف من بين أبناء السَّرَاة المصريين. وتميز نثره في هذه المرحلة من حياته بحسن الأسلوب، وكان يتضمن موضوعات اجتماعية وأخلاقية تُنبئ بمستقبلٍ باهر في عالم الكتابة والتحرير، ولا ننسى في هذا المقام سلسلة مقالاته في الوطنية، وكذا مقالاته الانتقادية للعادات والتقاليد.
أما المرحلة الثانية جاءت بعد حصوله على البكالوريا في عام 1911م، حيث سافر لدراسة الطب ببرلين، وقد ترك برلين وسافر إلى فرنسا ليدرس القانون متنقلاً بين باريس وليون. وكانت دراسته للقانون لا توافق ميوله؛ فكان يقضى كل وقته في المطالعات الأدبية الفرنسية. ولا شك أن هذا أثر في تكوينه النفسي واتجاهاته الأدبية؛ وقد ظهر هذا التأثير في كتاباته. وهذا ساعده على قيام ثورته الفكرية، وقد كان غيوراً على إصلاح المسرح المصري والأدب المصري؛ حيث رأى في فرنسا ما أعجبه وجعله يحس بمدى النقص الكبير والفرق العظيم بين الأدب المصري والأدب الغربي؛ ولذا فقد غير كثيراً من مذاهبه القديمة التي أيقن بخطئها، وهذا أكبر داع جعله يُهمل كتاباته في طوره الأول؛ لأن ما فيها من آراء قديمة يُخالف فكره الجديد في هذه المرحلة، ولأنها ليست في مستوى تفكيره الناضج الجديد. وكان حلمه أن يتم" تمصير الآداب" وقد نفذ هذا في رواياته المسرحية ونثره.
جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة أثناء قضائه إجازة الصيف بمصر؛ إذ أُعلنت الحرب العظمى (1914 – 1918م) التي نبشت أظفارها في العالم، وتوقفت الطرق، وتعطلت الأسفار، واضطر أن يستكمل حياته في مصر، دون أن يكمل تعليمه، ولكنه عاد إلى هواياته ومجالاته الفنية والثقافية القديمة.
وقد بدأ مجهوده في التمثيل بانضمامه إلى جمعية أنصار التمثيل مع رئيسها الأستاذ محمد عبد الرحيم في عام 1914م، وقد ترأَّس هذه الجمعية بعد وفاته. وكانت حفلات السمر التي يُقيمها النادي الأهلي في بدئها، فظهر فيها بإلقاء مونولوجاتٍ تمثيلية من نظمه، وعُد ذلك بداية عمله كممثل.
بعد ذلك بدأ ينظِم مقطوعات نظمية رقيقة، وعنى بنظم مونولوجات تمثيلية. وشارك في حفلات النادي الأهلي ونادي الموسيقى ونادي موظفي الحكومة؛ فكانت لا تخلو حفلة منها من مونولوج أو ديالوج له. وقد ذاع صيته بين هواة التمثيل والقائمين به، وكان كل شيء حوله يُسهِّل له الاندفاع في تيار المسرح: الثراء والشغف والحرية الشخصية. ولكن والده أحمد تيمور لم يكن راضياً عن ذلك.
ولا سيما أن النهضة التمثيلية التي عايشها كانت أكبر دافع له على ارتقاء المسرح؛ إذ كانت عظيمة جذابة في دورها الأول، وساعد على ذلك انضمام كثير من الطبقات المتعلمة الراقية إلى المسرح، ولقد اعتلى خشبة المسرح مُمثلاً في روايتين الأولى هي رواية "عزة بنت الخليفة" لإبراهيم رمزي. والثانية هي "العرائس" لبيير وولف، وترجمة الأستاذ إسماعيل بك وهبي المحامي.
وكان دائماً يبذل قصارى جهده في سبيلِ إيجادِ آداب مصرية بحتة بألوان محلية صحيحة، آداب تُعبر عن أخلاق وعوائد المصريين وتقدم صورتهم الصحيحة في بيئتهم بما تشمل من فضائل ونقائص. وخير دليل على هذا روايته المسرحية "ما تراه العيون" التي عُدت دليل على المجهود الكبير الذي وضع بتلك المسرحية، وقد عُدت أول دعامة في الأدب المصري الجديد والمسرح الوطني الحديث.
تُوفى في فبراير/شباط 1921 ولم يبلغ الثلاثين من عمره، ولكنه ترك من بعده تراثاً فنياً غنياً بما فيه من آراء وأفكار حية جريئة، وطُرُق لم يعهدها النقد الأدبي، وأسلوب فكاهي سلس يدل على مقدرة فنية اختُصت به دون سواه. وكان يمتاز بملاحظته الدقيقة، وهذا يُفسر براعته تصوير النفوس البشرية ومناظر الحياة على اختلاف مناحيها ومشاربها. وبالرغم من إنه تُوفى في عمر مبكر إلا أنه قام بتألَّف جميع أعماله في ستة أعوام وهي ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى "وميض الروح" التي تحتوي على ديوان تيمور، وهو مجموعة منظوماته. وكتاب الوجدان، وهو مجموعة قِطَعه الأدبية من الشعر المنثور والأدب والاجتماع، وهو مجموعة مقالاته الأدبية والاجتماعية، وما تراه العيون، وهو مجموعة أقاصيصه المصرية، وخواطر. وأخيراً مذكرات باريس. أما المجموعة الثانية وهي كتاب "حياتنا التمثيلية"، ويشمل الكتب الآتية، تاريخ التمثيل في فرنسا ومصر. والتمثيل الفني واللافني، ومحاكمة مؤلفي الروايات التمثيلية. ونقد الممثلين. ومقالات عامة عن التمثيل، القصائد التمثيلية (المونولوجات والديالوجات). وأخيراً رواية «الهاربة»، كوميدي دراماتيك مصرية أخلاقية في ثلاثة فصول. وجاءت المجموعة الأخيرة وهي كتاب "المسرح المصري"، ويحتوي على روايات العصفور في القفص: كوميدي مصرية أخلاقية في أربعة فصول. وعبد الستار أفندي: كوميدي مصرية أخلاقية في أربعة فصول.
محمود بك تيمور الأديب والقاص (1894 – 1973 م)
محمود بن أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور الكاشف، وُلِد بدرب سعادة بالقاهرة سنة 1894 م، وتعلَّم بالمدارس الأميرية. وقد كان هناك العديد من العوامل التي أثرت بشكل كبير في تكوينه حتى صار كاتباً؛ حيث ورث عن والده حب الأدب، وحببه في المطالعة والتأليف وحب اقتناء الكتب، وأذكى شقيقه فيه ذلك. ثم مطالعاته الخاصة هي التي وجهته في الحياة إلى تلك الوجهة التي كان ينتهجها في حياته الأدبية. وكذلك عمته السيدة عائشة التيمورية فقد أدركها في آخر عمرها، واستطاع أن يتذوق الشعر ويتفهمه قرأ الكثير من شعرها وحفظ مرثيتها لابنتها، وكان إعجابه بشعرها كبيراً، عاش مع والده في عين شمس بعد أن انتقلوا إليها، وقضى بها أطيبَ أيام صباه. وكان لوالده هناك مجالس علم عظيمة مع الشيخ محمد عبده، والشيخ الشنقيطي الكبير وغيرهما من كبار العلماء؛ فعاش في ذلك الجو وقتاً غير قليل، مستمتعاً بأحاديث الإمام، معجَباً بفصاحة الشنقيطي.
وقد كان العصر الذي يعيش فيه إذ ذاك تتسلط عليه المحافظة فاتبع الكُتاب طرائق السلف الصالح في الفكرة وأسلوبهم في التعبير، ولم تكن الكتابة غالبا إلا مدحاً للخلافة وتعلُّقاً بها؛ فلم يكن من أحد يُفكر في قومية أو وطنية. ومع اتساع البعثات إلى أوروبا وُجدت نهضة جديدة تدعو إلى التجديد في اللغة والأدب والاجتماع والسياسة والدين، ولكنها قُوبلت بالاستنكار؛ فكان زعماؤها سعد زغلول ومحمد عبده وقاسم أمين ثم أحمد لطفي السيد وتلاميذه. وقد شارك أخيه في رغبتَه في إقامةِ أدب مصري يستوحى مادته من المجتمع والبيئة المصرية.
ولما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها 1918م، ثارت في المصريين نزعةُ القومية اصطبغ الأدب باللون المحلي الصارخ، واتجه المصريون نحو الواقع. وقد شاع المسرح المحلي، وألَّف مجموعته القصصية الأولى "الشيخ جمعة" على غرار ما ألَّفه أخوه من مجموعة بعنوان "ما تراه العيون"، وأتبعها محمود بأخرى تحمل اسم " يُحفظ في البوسطة"، وكان شقيقه محمد خير مرشد له بما يُسديه له من ثقافة وموهبة أدبية رفيعة، وسار متبعاً المذهب الواقعي في كتابته متأثراً بالجو الجديد تاركاً الشعر المنثور، ولم يكن يحفل بالأسلوب احتفاله بتصوير الواقع. وبعد وفاة أخيه محمد استكمل ما كانت تصبو إليه نفس شقيقه؛ وبدأ يكتب، فتجمع عنده حتى سنة 1925م مادة من القصص طبعها في كتاب تحت عنوان "الشيخ جمعة وقصص أخرى" واستمر في التألَّيف.
وعامذاك سافر إلى أوروبا وقضى بها أكثر من عامين تفرغ فيهما للقراءة، ودرس نظريات الأدب الرفيع فترك اللون المحلي واتجه نحو النفس البشرية يُصور منازعها مُطْلِقًا روحه على سجيتها، غير متمذهب بمذهب، معتقداً أن المذاهب الأدبية ما هي إلا مقاييس منطقية وضعها النقاد، فلا يجب أن يتقيَّد بها الأدباء.
فقد ألَّف محمود تيمور بك نحو سبعين كتاباً، بعضها مجموعات من قصص قصيرة؛ إذ كان صاحب أول قصة قصيرة في الأدب العربي، وبعضها قصص تمثيلية، والبعض روايات قصصية مطوَّلة، ومنها كتاب في الرحلات على نحوٍ مستحدَثٍ في الأدب العربي، ومنها كذلك كتاب مقالات ساخرة في نقد المجتمع، وآخَر في أصول فن القصص ودقائقه. وألَّف كذلك قصصاً «سينمائية» مُثِّلت منها على الشاشة الفضية روايته «رابحة»، فكانت مسرحيةً موفَّقة في عالم الخيالة. فأكثر جهود تيمور بك متجهة كما يظهر إلى نوعين من القصة: التمثيلية، والقصة القصيرة …
وقد كانت القصة التمثيلية عنده أسلوباً في الكتابة لا يقصد بها الاتجاه إلى التمثيل على المسارح؛ فتمثيليات تيمور أقربُ إلى أن تكون نوعاً آخَر من القصة القصيرة. ولم يخرج من تمثيليات «تيمور» على المسرح إلا عدد محدود، وكان آخرها تمثيلية «حواء الخالدة» التي كان لها أكبرُ حظٍّ من التوفيق.
ولعل مجموعة قصصه “فرعون الصغير" هي التي تُمثل روح فنه في العصر الأول، وهو يسير فيها — على عادته — يرسم الأشخاص ففي براعةٍ حتى يكاد القارئ يلمح فيهم بعضَ مَن عرف من جيرانه، ولكن حماسة الشباب تبدو واضحة في أسلوبه؛ ففيه يعلو صوته، وتشتد حركته حتى لقد تبلغ ما يشبه العنف، ثم هو يعمد أحياناً إلى شيءٍ من المفاجأة، وقد يظهر ما ينم عن الحنق أو الأحكام الخلقية.
وكتب محمود تيمور كثيراً في القصة والمسرحية والبحث، وتُرجمت بعض قصصه إلى الفرنسية، والإنجليزية، والألمانية، والإيطالية، والروسية، والصينية، والإسبانية، وامتازت قصصه ورواياته ومسرحياته بتحليل العواطف الإنسانية، إذ كان يستلهم أحداثها من الواقع والبيئة، وكان في تصويره بعيد النظر، فجاء أدبه ذا طابع إنساني. كما كان له في ميدان الصحافة مجهود كبير؛ فما من مجلة أو صحيفة أسبوعية أو يومية إلا تلمح فيها آثاره القصصية ومقالاته الاجتماعية على نحو مبتكَر يفيض إصلاحًا، ويُخالط الجدَّ فيه روح ساخر من المداعبة والنقد الأصيل في ثوب يُشيع الفن في جنباته ونواحيه.
وقد حظي بمكانة وتقدير كبيرين بين الأدباء والنقاد ونال اهتمام وتقدير المحافل الأدبية والجامعات المختلفة في مصر والعالم، ففي عام 1947م تم منحه جائزة القصة من قبل مجمع فؤاد الأول للغة العربية، وكان ذلك تتويج لجميع الإنتاج القصصي باللغة الفصيحة لمحمود تيمور بك. كما حصل في عام 1950م على جائزة الدولة في الآداب، وفي العام التالي حصل على جائزة بطرس غالي بباريس، ومُنح جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1963م من المجلس الأعلى للثقافة، واحتفلت به جامعات روسيا والمجر وأمريكا.
وتُوفى محمود تيمور عن عمر يُناهز 80 عاماً في 25 أغسطس/ آب 1973م بلوزان بسويسرا. بعد أن أثرى المكتبة العربية والأدب العربي بأكثر من سبعين كتاباً في القصة والرواية والمسرحية والدراسات اللغوية والأدبية وأدب الرحلات.
من الملفت للنظر والثابت ، أن جميع أفرد الأسرة التيمورية انصب جل اهتمامهم على تعلم اللغات مثل العربية والتركية، وقد قام إسماعيل تيمور بتعلم اللغة الكردية حسب ما ذكر محمد عوني رسالته المعنونة بـ " الرسالة العونية في الأسرة التيمورية " والتي أوضح فيها أن محمد تيمور الجد جاء إلى مصر وهي يُجيد الكُردية لغته الأم، وكذا أنه علم ابنه إسماعيل تيمور لغته الكُردية أيضاً وبالتبعية علم إسماعيل ابنه أحمد تيمور الكُردية، إلا أن باقي أفراد الأسرة لم يتعلموها ربما بسبب السياق الإسلامي العربي، وكان هذا جلى في كل المصادر التي تعرضنا لها، وهم ذو أصول كردية، ولكن بعد انتقالهم من الوطن الأم إلى الموطن جعلهم يبتعدوا رويداً رويداً عن لغتهم وثقافتهم الكُردية وانخراطهم في الثقافتين العربية والتركية الرسميتين حينها في الموطن الجديد.
وعليه تظل الأسرة التيمورية، كغيرها الكثير من العائلات والأشخاص الكرد الذين ساهموا في إغناء الحياة الثقافية والاجتماعية والحضارية في مصر والكثير من البلدان العربية ودول المنطقة كأحد المكونات الرئيسية والأصيلة في المنطقة، وهذا التشابك والتعاون التاريخي والتكامل الثقافي والشعبي يمكن أن يكون أرضية وبنية جيدة لتعاون الشعوب العربية والكردية في الوقت الحالي مهما كانت الصعوبات والتحديات.