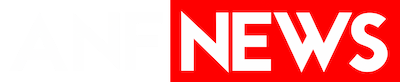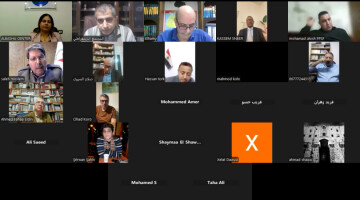وقال تحليل لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه مع وقوعاقتصاد التركي تحت ضغط شديد بالفعل، تواجه تركيا الآن أيضا عقوبات أمريكية بسبب شرائها لصواريخ الدفاع الجوي الروسية وعقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب استمرار انشطة التنقيب عن الغاز قبالة ساحل قبرص. وبالنسبة لبلد كان يعتقد ذات يوم أن طريقه نحو القوة والازدهار يمر عبر حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، فإن هذا الأمر يمثل تحولا جذريا. إذ يبدو أن قادة تركيا يعتقدون الآن أن المواجهة المباشرة للولايات المتحدة وأوروبا هي أفضل طريقة لتعزيز مصالحهم.
وقال تحليل للباحث نيك دانفورث حول "تراجع وسقوط التحالف الأمريكية-التركي" أن الوضعية الراهنة للعلاقات التركية الأمريكية المأزومة كانت نتاج لعقود لمشاكل كانت تتفاقم، ولكن لم تقع خلالها سلسلة التطورات المشؤومة وربما لم تتكلل بسقوط دراماتيكي.
طوال الحرب الباردة، شعرت تركيا بالصدمة لكونها الشريك الأصغر لواشنطن، لكنها تحملتها مقابل الحماية من الاتحاد السوفيتي. ونتيجة لذلك، كانت المشاعر المعادية لأمريكا واسعة الانتشار في تركيا عندما وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، الذي كان له شكله الإسلامي الخاص إلى السلطة في نهاية عام 2002.
ومع ذلك، حاول حزب العدالة والتنمية في البداية تعزيز مكانة تركيا في عالم مستقر بشكل أساسي، بقيادة الغرب من خلال استخدام القوة الناعمة لتركيا في الشرق الأوسط، واشار الكاتب الى ان أحمد داود أوغلو، مهندس السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية، كان وجهة نظر مبالغ فيها حول ما يمكن أن يحققه تأثير تركيا الدبلوماسي والثقافي والاقتصادي. وأثبتت بعض جهوده المميزة، مثل محاولة التوسط في السلام بين إسرائيل وسوريا، عدم نجاحها، وكذلك اقتراحه عام 2010 للتوصل إلى اتفاق نووي إيراني، لم يكن مفيدًا بشكل واضح من وجهة نظر واشنطن.
مع بداية الربيع العربي في أواخر عام 2010، تطورت طموحات تركيا. فجأة، وسط الفوضى، رأى داود أوغلو وأردوغان فرصة لشيء أقرب إلى ما يمكن أن يُطلق عليه معنى "السياسة الخارجيةالإسلامية"، أي المساعدة في جلب القوى المتحالفة مع الإخوان المسلمين إلى السلطة في جميع أنحاء الشرق الأوسط حتى لو كان ذلك يعني المواجهة المباشرة مع نظام بشار الأسد في سوريا ومع إيران. لكن هنا أيضاً، ظلت أهداف تركيا الأيديولوجية متوافقة بما فيه الكفاية مع توقعات واشنطن الليبرالية، والتي يمكن خلالها للإسلاميين المعتدلين أن يصلوا للسلطةمن خلال الانتخابات. حيث كان بعض المحللين مفرطين في التفاؤل بشأن ما سمي "النموذج التركي".
"وبدلاً من ذلك، أدى فشل الربيع العربي في نهاية المطافإلى تضخيم الاختلافات الاستراتيجية بين واشنطن وأنقرة، بينما ساهم ذلك بالنسبة لأردوغان في تأكيد بعض من أسوأ شكوكه حول الغرب. ومن هذه النقطة فصاعدا واجهت حكومة أردوغان معارضة داخلية مكثفة، وانتقاد غربي، ومقاومة إقليمية، والتي يبدو أنها تضافرت لخلق شعور عميق بالحصار."
"في صيف عام 2013، على سبيل المثال، تزامنت الاحتجاجات الجماهيرية في الشوارع التي أدت إلى تحرك الجيش ضد الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين في مصر مع اندلاع الاحتجاجات في حديقة غيزي ضد استبداد أردوغان المتزايد في تركيا. ورغم أن وسائل الإعلام الغربية التي كانت متعاطفة ذات يوم قد بدأت بالفعل في التشكيك في مؤهلات أردوغان الديمقراطية، فإن دعمها المتحمس لاحتجاجات غيزي كان بمثابة تغيير واضح في لهجتها. كما سارع الكثير من المعلقين الغربيين إلى انتقاد الاحداث في مصر. ولكن من وجهة نظر أنقرة، كان التناقض بين تشجيع الغربيين المتظاهرين في منتزه غيزيورفض واشنطن إدانة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تولى الحكم بعد مرسي، هو تعبير عن النفاق الغربي فيما يتعلق بموضوع الديمقراطية"، على حد وصفه.
لعب الوضع في سوريا خلال العام التالي دوره المدمر بشكل فريد بالنسبة للعلاقات الامريكية التركية. مع تنامي قلق واشنطن تدريجياً بشأن الدعم التركي للجماعات المتطرفة المرتبطة بالقاعدة، أصبحت تركيا تشعر بالقلق أكثر من أي وقت مضى بشأن قوة الكرد السوريين، حيث رأت أن الجماعات الإسلامية المتطرفة لها ثقل موازن وجذاب. ومما زاد الطين بلة، سرعان ما أعقب احتجاج غيزي انفصال درامي بين أردوغان وفتح الله غولن، الذي دعم صعود أردوغان إلى السلطة. وعمل غولن كحليف لأردوغان، وساعدته حركة غولن على تلميع سمعته في واشنطن. لكن عندما انقلبت عليه الحركة في نفس الوقت الذي كان فيه الرأي الغربي ناقدا لسياساته، سارعت الكثيرين في تركيا برؤية علاقة تآمرية بين الطرفين.
سرعان ما عمقت الأحداث على مدار الأعوام القادمة كل هذه الانقسامات، بينما كانت الحكومات التركية الأخرى قد تخفف من مواقفها لتجنب الوقوع في مشكلات معشركائها، كان أردوغان أكثر ميلًا إلى مضاعفة الانقسامات والخلافات، حتى لو كان ذلك يعني العزلة.
بعد اطاحة الاخوان في مصر، ظلت أنقرة تعارض بشدة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بينما قررت السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتى إسرائيل دعمه. عمق هذا الاصطفاف الاستقطاب والصدع الإقليمي، وسرعان ما وجدت تركيا نفسها مقيدة ضد تلك البلدان في مجموعة من القضايا، تمتد من ليبيا إلى القرن الأفريقي. وعندما فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بدعم من واشنطن على ما يبدو، حصارًا على قطر في عام 2017، اندفع أردوغان إلى دعم قطر، مقتنعًا بأنه يمكن أيضًا أن ينتهي به المطاف في نفس المكان. والآن، في شرق البحر الأبيض المتوسط، جعل التعاون بين اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل إحساس أنقرة بأنها مطوقة ومحاصرة أقرب ما يكون لأراضيها.
في هذه الأثناء، في سوريا، ساعدت رغبة أنقرة في الجلوس والترقب على أمل أن يهزم تنظيم داعش منافسيه الكرد السوريين في نهاية المطاف في جعل نظرية المؤامرة التركية القديمة حقيقة واقعة. فطوال الحرب الباردة، دعمت الولايات المتحدة تركيا بقوة ضد حزب العمال الكردستاني "الماركسي"، بحسب وصف المقال. ولكن مع حرب العراق الأولى والثانية، وجدت واشنطن نفسها تدعم الكردالعراقيين في محاولتهم للحصول على الحكم الذاتي. وأثار ذلك جنون لدى العديد من الأتراك. وهكذا، عندما بدأت واشنطن بالفعل في دعم وحدات حماية الشعب، بدا أنها تؤكد أسوأ مخاوف الأتراك لدرجة أنها ساعدت في توحيد تحالف أردوغان، مع فصيل مهم من القوميين في البلاد.
بالطبع، لم يحث شيء أكثر لجعل السياسة الخارجية مسألة وجودية لأنقرة أكثر من "محاولة الانقلاب" عام 2016. وخلص أردوغان إلى أن أعضاء حركة غولن كانوا وراء الانقلاب الفاشل وهذا يعني أن واشنطن كانت كذلك. ومع فشل تسليم غولن من الولايات المتحدة، حيث يعيش في المنفى في ولاية بنسلفانيا، زادت الشكوك التركية.
بعد محاولة الانقلاب، اتخذت المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا نبرة عاطفية بشكل خاص، حيث يكافح الكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين لشرح المنطق وراء السياسة الأمريكية للجماهير التركية المعادية. وفي بعض الأحيان، مثل شرح قرار واشنطن بالعمل مع وحدات حماية الشعب ضد تنظم داعش وطلب أدلة من تركيا لتسليم غولن.
وعلى نفس المنوال، فإن الرغبة المبررة للإدانة الفورية لقرارات السياسة الخارجية التركية بعد محاولة الانقلاب، جعلت من الصعب على واشنطن فهم هذه القرارات والتنبؤ بها بشكل صحيح - كما يتضح من الاقتناع السائد بأن أردوغان سينهي في النهاية عن صفقة روسيا لبيع منظومةالصواريخ اس-400، ويميل الأمريكيون إلى تفسير عدد من تحركات أردوغان الأكثر استفزازية باعتبارها محاولاتابتزاز للحصول على تنازلات ملموسة. من هذا المنظور، كان طلب شراء S-400s من روسيا ورقة مساومة للتوصل إلى صفقة أفضل على صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية باترويت، وكان اعتقال المواطنين الأمريكيين والموظفين القنصليين محاولة للحصول على غولن، ونشر تفاصيل عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية، في اسطنبول كانت محاولة لابتزاز الرياض، ربما حتى مقابل المال.
ومع ذلك، قدمت أنقرة باستمرار مثل هذه التحركات من حيث أنها أكثر دفاعية وأكثر طموحًا. أي أن تصرفاتها الصدامية تبدو بدافع من الاعتقاد بأنهم وحدهم يمكنهم مساعدة أنفسهم في إعادة ضبط شروط علاقاتهم مع الغرب وإجبار واشنطن على إعادة النظر في سياساتها العدائية. واقتناعا منها بأن تركيا مهمة للغاية بالنسبة إلى الغرب وصعب خسارتها، وسعت أنقرة إلى رفع ثمن تجاهل مصالحها مع توقع أن تتراجع الولايات المتحدة في نهاية المطاف.
في عالم أكثر فوضوية وتهديدًا، تضع أنقرة بشكل متزايد ثقتها في القوة الخشنة/ العسكرية. في أوائل عام 2018، على سبيل المثال، عندما تحركت واشنطن لتعزيز موقع وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا، شنت تركيا غزوًا لعفرين، وأعلن الأتراك أن استعراض القوة هذا سيثبت أنه لا يمكن تجاهل تركيا، وقد ادعوا ذلك عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من سوريا في وقت لاحق من ذلك العام. والآن، تتبع تركيا نفس النهج في مطالبتها بموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، حيث ترسل سفن حربية لتعطيل بحث قبرص عن الغاز الطبيعي بينما تقوم بعملية بحث خاصة بها. كما قال أردوغان، "كما علمنا درسًا للإرهابيين في سوريا، لن نتنازل أمام قطاع الطرق في البحر".
المشكلة بالنسبة لصانعي السياسة الغربيين، بما في ذلك الأمريكيين الذين يتخذون حاليا قرارًا بشأن مدى قوة العقوبات التي ستفرض على تركيا على خلفية صفقةصواريخ S-400، هي أن الرد العدواني المفرط يؤكد اعتقاد تركيا بأن الولايات المتحدة معادية بشكل جوهري لها، في حين أن موقفًا ضعيفًا يؤكد اعتقادها بأن رد الفعل العدواني كان أمرا ناجحًا مع الأمريكيين. وتركيا بدورها تواجه مشكلة أكبر. قد تتحقق التحركات الاستفزازية من بعض السياسات التي تجدها أكثر إشكالية على المدى القصير، ولكن كما يحدث بالفعل، فإنها ستعمق في نهاية المطاف العداء والحصار ومخاوف أنقرة.