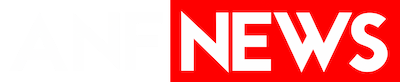خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت حضورا مصريا متناميا في السياسات الإقليمية والدولية بعد غياب لعقود، كثيرا ما سمع المراقبون عبارة إن "مصر أجهضت المشروع التركي في المنطقة" بفضل ثورتها على نظام الإخوان الذي كان الحلقة الأقوى في سلسلة أو حزام إخواني أريد لمقبضه أن يظل بيد أنقرة أو ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد الذي قال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أنه شخصيا يتولى مسؤوليته "كرئيس مشارك" دون الإشارة للعضو الآخر أو الأعضاء في هذه "الهيئة الرئاسية" للإقليم.. ويبدو أن المواجهات المتكررة بين مصر وتركيا وعلى رأسها الساحة الليبية ومنطقة شرق المتوسط قد أكدت مدى ارتباط الخلافات بين الجانبين برؤية كل من الطرفين للقضايا الإقليمية ومصالح كل طرف فيها، أو بمعنى أدق نحن أمام صدام لمشروعين ودورين إقليميين، بغض النظر عن الأسباب النابعة مباشرة من مصفوفة علاقاتهما الثنائية التي لا تخلو أيضا من خلافات تصل حتى إلى وجود "حاجز" شخصي بين قيادتي البلدين، ربما عبر عنه الجانب التركي كثيرا.
لكن مع عودة الحديث عن امكانية التصالح بين مصر وتركيا، بالتزامن مع مجئ إدارة جديدة إلى البيت الأبيض وإعلان المصالحة "الخليجية" أو القطرية-السعودية، يطرح التساؤل نفسه.. هل بتنا على أبواب إعلان مصالحة بين القاهرة وأنقرة؟ وما هي مقومات هذه المصالحة؟ وهل هي قابلة للإستمرار أم مجرد تهدئة ظرفية إنتظارا لوضوح مسار السياسة الدولية والإقليمية في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن؟
غياب البوصلة وخارطة الطريق نحو المصالحة
لا تعكس تصريحات "الغزل" التركية تجاه مصر حقيقة مواقف أنقرة من هذا الملف، فالحديث تكرر كثيرا عن وجود إتصالات ولقاءات من "الأبواب الخلفية" بين الجانبين، حتى خلال أقصى درجات ومراحل التصعيد التي شهدت تهديدا باستخدام القوة المسلحة لردع التهديدات بين الجانبين كما جرى الصيف الماضي وتحديدا حينما حددت القيادة المصرية ما وصفته بالخط الأحمر للأمن القومي المصري في ليبيا، متحدية أن تواصل أنقرة دعمها لحكومة الوفاق أو الميليشيات المتحالفة معها، فنحن لسنا أمام تحول جديد، بل لسنا أمام مبادرة من الجانب التركي، ولا استجابة من الجانب المصري الذي وصف النهج التركي في آخر تصريح رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية بأنه "يفتقد إلى المصداقية" بمعنى أن هذا النوع من التصريحات "لم يعد ينطلي علينا"، ليردد كثير من المعنيين في مصر أن القاهرة تنتظر "أفعال لا أقوال"، فالتصريحات التركية تجاه مصر مجرد مضاربة في بورصة الكلام الذي تريد تركيا من خلاله إقناع العالم بأن هناك مراجعة لسياستها الخارجية وتماشيا مع ظروف الطقس السياسي الدولي الجديد، وأيضا ردا على إنتقادات عديدة وجهتها المعارضة لسياسة حزب العدالة والتنمية في المحيط الإقليمي ولفشل حكومة أردوغان في إدارة علاقاتها مع مصر وافتعالها للمشكلات التي لا طائل من وراءها، لا في شرق المتوسط ولا في ليبيا أو غيرها.
الجانب المصري أيضا لم يحدد طبيعة "الأفعال" التي يريدها أو الخطوات التي يمكن أن ترضيه، وإن كان قد تحدث عنها في مناسبات عدة، لكن ترك الأمور غامضة في هذه اللحظة، ربما يعني أن الملف لا يحظى بأولوية زمنية بالنسبة للقاهرة، وقد يعني أيضا أن الحوار لا يرتبط بشروط مسبقة ما يزيد –وفقا لنظر البعض- من احتمالات التفاهم، لكن في الواقع قد يشير إلى غياب أي أرضية مشتركة للتفاهم، فالمطالب المصرية ربما تقتضي تغيير تركيا لنهجها برمته بما يشمل في نهاية المطاف مراجهة نظرة تركيا لدورها الإستراتيجي، وهو أمر مستبعد. فكيف ستكف تركيا عن التدخل في شؤون المنطقة حتى إذا توقفت عن التدخل في شؤون مصر وتهديد أمنها القومي في الصميم، وماذا نتوقع من المستقبل إذا كان إستعادة مصر لدورها أو على الأقل تأمينها لمصالحها في محيطها الحيوي ودوائر أمنها التقليدية أصبح مرتبط بصورة أو بأخرى بمواجهة النفوذ التركي والتحركات التآمرية لأنقرة في تلك الملفات؟ خذ على سبيل المثال دائرة شرق المتوسط وشمال وشرق أفريقيا بما في ذلك حوض النيل، دون الحاجة للإشارة لتفاصيل.
إذا أردنا النظر إلى ما يحمله المستقبل بالنسبة لسلوك تركيا، يكفي تذكر ما جرى خلال الشهور القليلة الماضية، لقد أصبحت التدخلات العدوانية التركية ضرورة حتمية لتسويق الصناعات الدفاعية التركية كوسيلة للخروج من المأزق الإقتصادي، ناهيك عن كونها الأداة المفضلة لتحقيق الأهداف العدوانية للسياسة الخارجية التركية في عهد أردوغان، فضلا عن تمهيد تلك التدخلات لوجود عسكري دائم لتركيا في مناطق عدة. وبينما تواصل أنقرة سياستها، تريد تركيا من مصر أن تتغاضى لها عن ما تفعله أو أن تتفاهم معها وتتقاسم معها المصالح كما تفعل بإنتهازية تامة مع موسكو، لكن ذلك يتجاهل حقيقة المبادئ والقيم التي كرستها سياسة مصر تجاه محيطها الإقليمي وتمتعت بدرجة كبيرة من الاتساق والمصداقية باتت معها محددا أساسيا لسياستها الخارجية التي تمثل إلى حد كبير نقيض السياسة الأردوغانية الإنتهازية. فإذا كان لا أمل في تغيير تركيا لسياستها، فهل ستفرض الظروف الدولية والإقليمية الجديدة على الجانبين مصالحة أو تهدئة "لابد منها"؟!
الملفات العالقة والشائكة
يجادل كثيرون بأن العلاقات بين البلدين لم تعد شأنا يخص مصر وتركيا فقط، فقد أصبحت مواقف حلفاء كل طرف، محددا أساسيا في رسم مستقبلها، فالخصومة أخذت بعدا تدويليا منذ بدايتها لتتحول إلى استقطاب إقليمي بين محورين من الخصوم ينتمون في الغالب إلى دول أوروبا والخليج بالإضافة إلى موقفي الولايات المتحدة واسرائيل، وبين هؤلاء يقع لاعبين ثانويين في معظم بلدان المنطقة المنقسمين حول تأييد كل محور والاستفادة من حالة الصراع القائم.
قد يرى البعض أن مصالحة الخليج التي رحبت بها تركيا، واهتمام التكتل الأوروبي بحدوث التقارب كما عبرت عنه دعوة المجلس الأوروبي الخميس الماضي، تمثل فرصة لدفع الطرفين نحو "تفاهم" أو حوار قد لا يمتلكان القدرة على إتمامه مباشرة أو منفردين. لكن نفس هذه الظروف قد تدفع إلى مزيد من التعقيد، فالمعادلة التي فرضتها مصر وشركائها في شرق المتوسط لا تسمح لتركيا بشغل المساحة التي ترضي طموحها الجامح أو تجعل أردوغان يخرج محققا للمكاسب التي اشعل من أجلها كل تلك الصراعات، وكذلك فإن مجمل التحركات المصرية واليونانية-القبرصية تشير إلى مزيد من الصلابة في مواجهة الجموح التركي، ولعل آخرها القمة الثلاثية التي أعقبها مناورات عسكرية شاركت بها الإمارات وفرنسا للمرة الأولى، وزيارات متبادلة رفيعة المستوى ركزت على تعزيز التعاون العسكري لحماية التعاون الإقتصادي الذي يجسده منتدى غاز شرق المتوسط ضد التهديدات التركية.
تلك التعقيدات والمنافسة الإقليمية، قد تتضائل أمامها معضلات كبيرة تم النظر إليها لسنوات كعقبة يستحيل معها إعادة العلاقات المصرية-التركية إلى ما كانت عليه، مثل ملف الإخوان، فرغم كل المحاذير لن يجد نظام أردوغان صعوبة في جعل مسألة التضحية بأنصاره مقبولة ضمن صيغة تتضمن تخفيف احتضان تركيا للإخوان وقنواتهم، فضلا عن الإلتزام بإبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن مصر واستقرارها، بعد أن تم وضع بعضهم على قوائم الإرهاب الأميركية كما جرى مع ما يسمى حركة "حسم" الإرهابية إحدى المجموعات التابعة للتنظيم.
ويقول محمد حامد الباحث في العلاقات الدولية ومدير منتدى شرق المتوسط للدراسات، إن من بين الشروط المصرية لتحسين العلاقات يبقى شرط إرسال السفير جديد إلى القاهرة، وما يعنيه من رمزية الاعتراف وغيرها، بعد سنوات أكد خلالها رئيس النظام التركي إنه يرفض شخصيا لقاء نظيره المصري. ويصف حامد ذلك بأنه "أول شرط وأبسط شرط ولكنه أصعب شرط من حيث التحقق"، معتبرا أن القاهرة تنتظر "تسوية عادلة غير قائمة على الغش أو الغبن أو الخدعة"، لكن "مستوى العلاقات الثنائية لن يتحرك إلا من خلال تبادل السفراء وعودة العلاقات الدبلوماسية"، كخطوة أولى.
واضاف حامد "العلاقات الإقليمية معضلة أساسية، فالعلاقات مع اليونان وقبرص والامارات هل يمكن التضحية بها وبالاستثمار في هذه العلاقات لسنوات؟ وبعضها والعلاقات التركية-الإثيوبية كذلك أيضا تمثل مصدر قلق للقاهرة، بينما كل ما يقوم به أردوغان من حديث عن النهج التصالحي تفاديا لعقوبات أوروبية وأمريكية، لم يثبت أي جدية، وهل تصالحه مع الخليج سيكون شاملا لمصر أم سيكون غير شامل لمصر؟ القاهرة ليست في عجلة من أمرها ولا يوجد شئ محفز على اتخاذ خطوات، فمصر ليس لديها ما يدفعها بالحاح إلى حسم ملف العلاقات الثنائية مع تركيا".
ويؤكد الباحث المصري المختص بالشأن التركي، أنه "لا أفق للتصالح مع تركيا وأن هناك خلافات كثيرة إقليمية وثنائية"، مستبعدا إقدام البلدين على تقارب محتمل كنتيجة للتحولات الراهنة التي لم تتضح بعد اتجاهاتها، مضيفا "لا يوجد طرف إقليمي يحسب حساباته بطريقة مسبقة على عكس ما يقال عن التمهيد للتعامل مع الإدارة الجديدة، الكل ينتظر ما سينتج عن وصول بايدن".